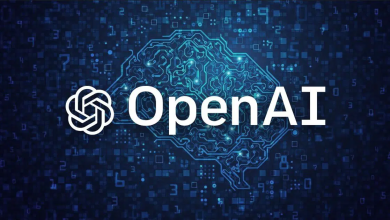بين الرغبات والصدف: فهم الأسباب وراء تطور الاقتصاد من خلال النظرية الجديدة للنمو

ظل النمو الاقتصادي ومحدداته القضية الأساسية لعلم الاقتصاد منذ نشأته قبل نحو 200 عام على يد “آدم سميث”، واختلفت مدارس الفكر في تفسير هذه الظاهرة والعوامل المؤثرة عليها.
إذ افترضت نظريات النمو الخارجي التابعة للمدرسة الكلاسيكية الجديدة أن النمو الاقتصادي، واستمرار الإنتاجية يتوقفان على التطور التكنولوجي وحده، والذي تعتبره عاملاً خارجياً قائماً على الصدفة ولا يخضع لتحكم الفرد أو صانع القرار، وبالتالي تتوقف رفاهية أفراد المجتمع على مؤثرات عشوائية.
في حين رأى فريق آخر من هذه المدرسة أن نمو الاقتصاد يتوقف على عوامل وتفاعلات داخلية تؤدي إلى حدوث تطورات تكنولوجية تُعزز الإنتاجية.
اتفق الفريقان على أن التطور التكنولوجي أحد المحددات الرئيسية لنمو الاقتصاد والإنتاجية، بينما رأى أنصار نظرية النمو الداخلي أن هذا النمو يتوقف على عوامل أخرى مثل الاستثمار في رأس المال، وقرارات الحكومة، وزيادة القوى العاملة.

وبالتالي، وعند افتراض ثبات المعروض من العمالة ومستوى التقدم التكنولوجي في الأجل القصير، سوف يتوقف النمو الاقتصادي بمجرد وصول الإنتاج لوضع التوازن بناءً على عوامل الطلب الداخلي، وحينها تصبح المؤثرات الخارجية ضرورية لتحفيز النمو مجدداً.
على العكس من ذلك، ترى النظرية الجديدة للنمو أن زيادة إنتاج الاقتصاد تعتمد على مبدأ لا محدودية الحاجات الإنسانية وحافز الربح، وبالتالي يخضع النمو الاقتصادي لتطلعات ورغبات أفراد المجتمع، وليس عوامل خارجية عشوائية، أو قرارات حكومية.
تقوم النظرية على مبدأ تقلص الربحية نتيجة تصاعد المنافسة في الاقتصاد، ما يدفع الأفراد إلى السعي المستمر لابتكار طرق إنتاج جديدة لتعظيم أرباحهم، وبالتالي يعد هذا الدافع الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.
وحسب فروض النظرية، يتمتع الأفراد بالقدرة على التحكم في رأس المال المعرفي للاقتصاد، واختيار مجالات العلم التي تتوافق مع تطلعاتهم الاقتصادية.
وتتعامل النظرية مع المعرفة كأصل يساعد على نمو الاقتصاد، ونظراً لطبيعتها غير المادية، لا تخضع المعرفة لظاهرة تناقص الإنتاجية مثل الأصول الأخرى من معدات وعقارات، وبالتالي تؤدي زيادتها بشكل مستمر إلى ارتفاع متواصل في الإنتاج، ولا يتوقف النمو على حدوث صدمات خارجية إيجابية في الأجل الطويل ينتج عنها تطورات تقنية.
بل يصبح التطور التكنولوجي عملية داخلية تحدث، وفق مقتضيات الوضع الاقتصادي، وديناميكيات السوق والمنافسة بين أطرافه، ومن ثم يسعى الأفراد إلى تكثيف استثمارهم في رأس المال البشري سعياً لتحقيق مزيد من الأرباح.
أحد الفروض الأساسية للنظرية الجديدة للنمو هو أن الشركات بصفة عامة عادة ما تُقلل من أهمية تنمية المعرفة من أجل زيادة الربح، وبالتالي تقع مهمة الاستثمار في رأس المال البشري على عاتق الحكومات، وذلك من خلال توفير مستوى تعليمي أفضل، وتيسير حصول الأفراد عليه، وتوفير حوافز للقطاع الخاص من أجل زيادة أنشطة البحث والتطوير.
تكمن أهمية النظرية الجديدة للنمو في أنها أولاً تتعامل مع المعرفة والتقدم التكنولوجي كعوامل داخلية للاقتصاد تنشأ، وفق تفاعل قواه المتختلفة، وتخضع لإرادة المجتمع، وثانياً، أن هذه المعرفة تعد هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

إذ عجزت نماذج المدرسة الكلاسيكية الجديدة عن تفسير معضلة تفاقم مشكلة انعدام عدالة التوزيع في الاقتصاد العالمي رغم تحسنها في دول متعددة، أو تفاقم المشكلة داخل أحد الاقتصادات رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، كما في حالة دول مثل الصين والهند.
حيث يرتبط الاختلاف في مستويات المعيشة بين الدول، وبين المناطق الجغرافية داخل الدولة ذاتها، باختلاف كميات رؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات البنى التحتية بهذه المناطق.
وإذا كان حل مشكلة تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات رفاهية الأفراد هو الاستثمار في رأس المال المادي، فإن تجربة الاتحاد السوفيتي كانت دليلاً على فشل هذا النهج.
والسبب في ذلك هو أن تغير رأس المال المادي يُفسر فقط قرابة ثُلث التغيرات في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مختلف الدول، وعلاوة على ذلك، يخضع لقانون تناقص الإنتاجية، بمعنى أن زيادته باستمرار لن تؤدي إلى ارتفاع بنفس القدر في الإنتاجية مع افتراض ثبات حجم القوى العاملة.
في حين يرجع ثُلثا هذه التغيرات إلى ما يُطلق عليه الاقتصاديون مصطلح “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج”، ورغم عدم توصل العلماء إلى كافة العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، لكنهم اتفقوا على وجود 3 متغيرات رئيسية تتحكم بها، ألا وهي إنتاجية العمالة، وكفاءة تخصيص الموارد، والتجارة الدولية.
ويرتبط المتغيران الأول والثاني ارتباطاً وثيقاً بالحافز الفردي للربح، والسعي لاكتساب الأفراد مزيداً من المعرفة لابتكار سبل إنتاج ذات كفاءة أعلى، الأمر الذي يدعم فروض النظرية الجديدة للنمو.